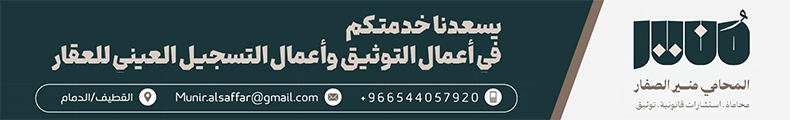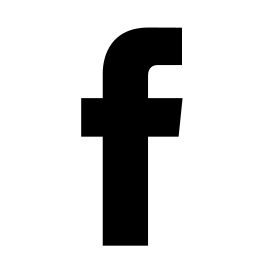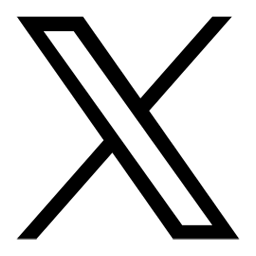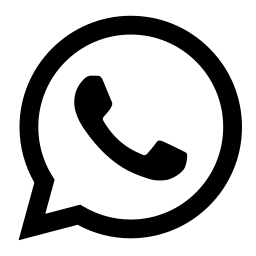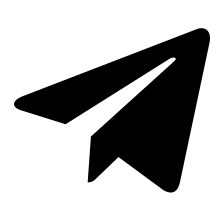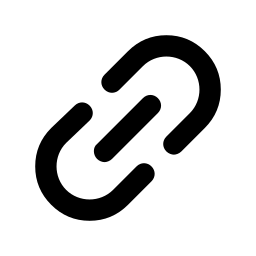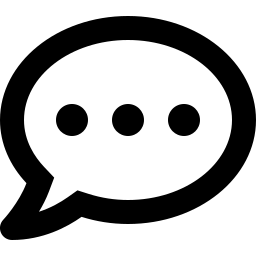هل ما زلنا عائلة… أم مجرّد أرقام في الهواتف؟
على الرغم من تزايد وسائل التواصل وسهولة الوصول بين أفراد الأسرة، إلا أن كثيرًا من البيوت تفتقد اليوم حضورًا إنسانيًا حقيقيًا لا يعوّضه أي جهاز. فالرسائل والمكالمات، مهما كثرت، لا تستطيع أن تحلّ محلّ كلمة صادقة تُقال في وقتها، ولا موقف إنساني يشعر به من يحتاجه. وهنا تتكشف أزمة جديدة تعيشها الأسر: كيف نبدو قريبين بالوسائل… وبعيدين بالمشاعر؟
الحضور داخل الأسرة لا يُقاس بعدد الاتصالات، ولا يُختصر في ظهور الاسم في مجموعات العائلة، بل يُقاس بالأثر الذي يتركه الفرد في قلوب أهله. فالفرد الفاعل هو الذي يمنح أسرته جزءًا من وقته، ويشاركهم لحظاتهم، ويلتفت إلى التفاصيل التي تبني المودة وتقوّي الروابط. وهو يدرك أن دوره ليس شكليًا، بل ضرورة تحافظ على توازن البيت واستقراره.
وتشير التجارب الاجتماعية اليومية إلى أن العلاقة التي تُروى بالسؤال والاهتمام تبقى قوية وقادرة على مواجهة الضغوط، بينما العلاقة التي تُترك للمناسبات أو الظروف تبدأ بالضعف تدريجيًا، حتى تصبح مجرد مجاملة أو عادة اجتماعية. فالتواصل البارد — مهما تكرر — لا يصنع أُسرة، كما أن الهاتف مهما كان قريبًا لا يقدّم دفئًا يعادل لحظة حضور صادق.
غياب الأفراد عن أدوارهم داخل الأسرة يترك أثرًا يتجاوز اللحظة. فهو يخلق فجوات في قلوب الأبناء والناشئة الذين يتعلمون معنى الأسرة من الأفعال لا من الكلمات. ويؤثر على الكبار أيضًا، لأن العلاقات العائلية تحتاج إلى تجدد مستمر، ومواقف تذكّر كل فرد بأنه جزء أساسي من هذا الكيان الإنساني.
ومن هنا يصبح السؤال: هل ما زلنا نعيش معنى الأسرة حقًا، أم أصبحنا مجرد أرقام محفوظة في الأجهزة؟ فالكلمة الطيبة، والسؤال الصادق، والزيارة الخفيفة، كلها أفعال صغيرة لكنها تؤسس لبيت قوي لا تهزّه المسافات ولا تغيّره الأيام. أما الاكتفاء بالاتصالات الباردة، فهو حضور ظاهري لا يُسند أحدًا ولا يبني علاقة.
فالأسرة لا تحتاج إلى الكثير؛ تحتاج إلى من يحضر بقلبه قبل صوته، ومن يرى أهله بصدق لا عبر شاشة. وكل اهتمام نقدّمه اليوم يعود علينا غدًا روابط أقوى، وطمأنينة أعمق، وبيتًا يشعر فيه الجميع بمعنى القرب الحقيقي.
إن استمرار الأسر في عصر السرعة ليس تحديًا في الوسائل، بل في القلوب. فالهاتف قد يقرّب المسافات… لكنه لا يصنع عائله